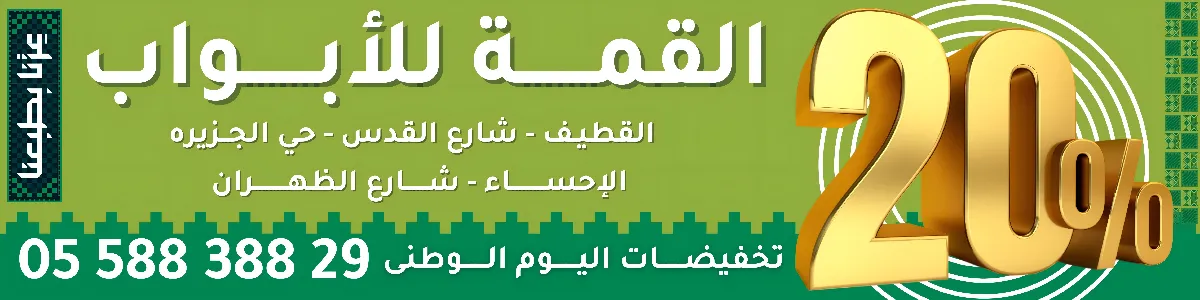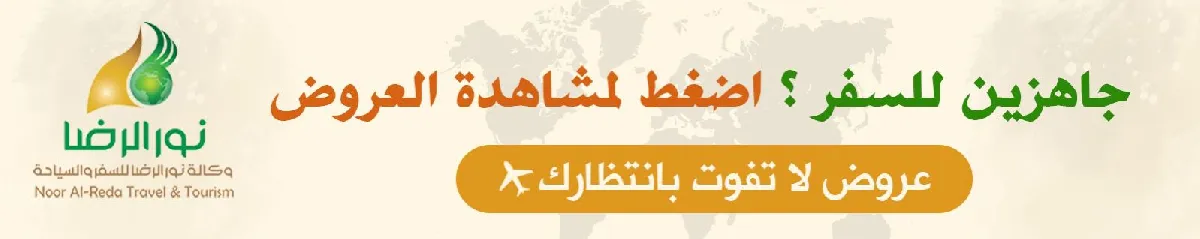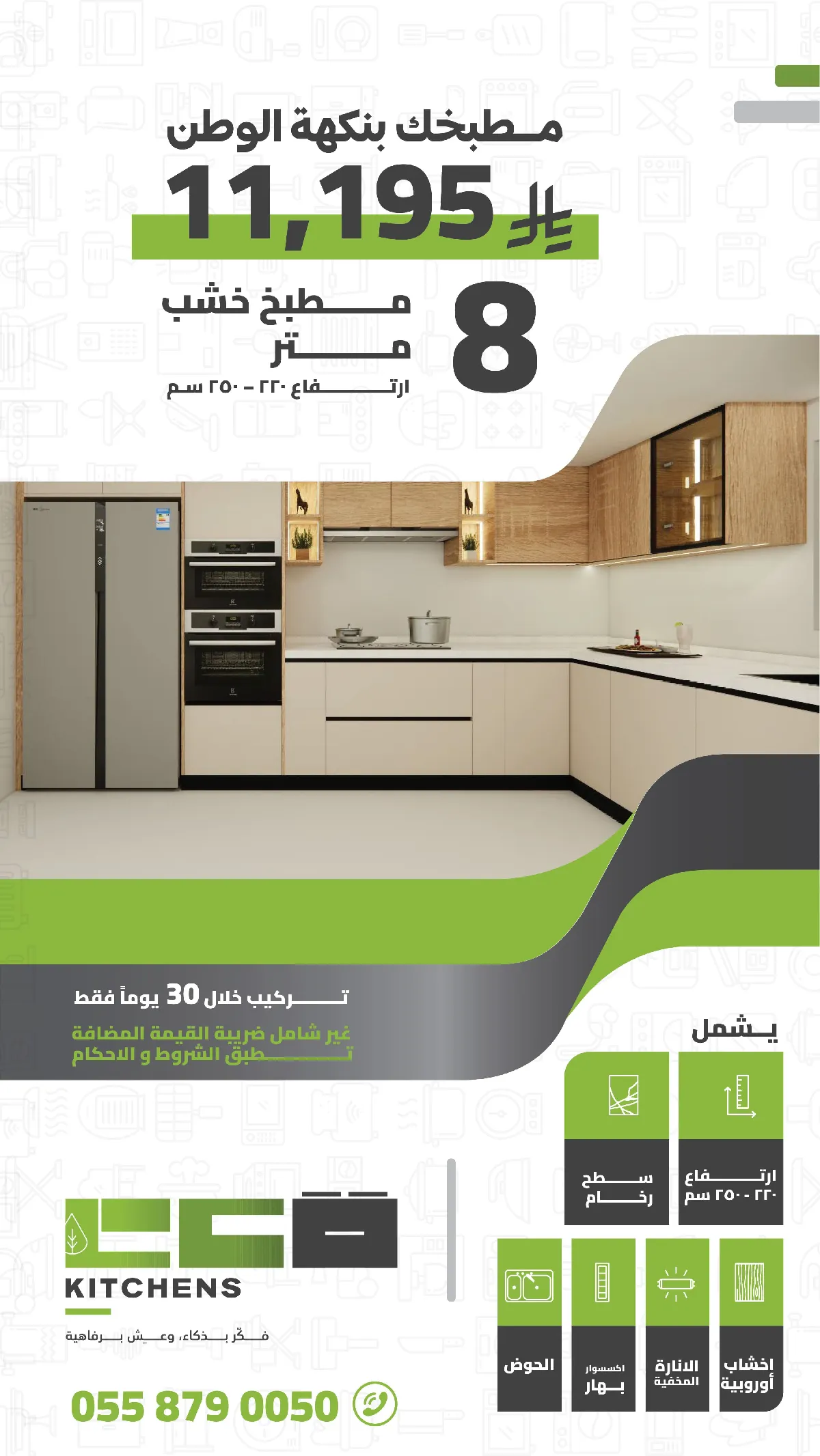في عالم محموم ومهووس بالسرعة، نجد أن شعار “الأسرع هو الأفضل” يحظى عند الكثيرين بقيمة عالية، وليس فقط في شؤون محددة، ولكن في شتى المجالات، وأيضًا ضمن مراحل حياة الفرد. فمنذ أن يبدأ الطفل في التعلم، ودخوله المدرسة حتى قضاء سنوات عديدة في الوظيفة، يتدرب ويمارس بشكل يومي السرعة من أجل الحصول على مكاسب علمية ومادية وترقيات عملية وتحقيق النجاح والوصول إلى أهداف محددة. كل هذا من المرجح أن يحدث لأي واحد منا، لأننا نعيش في عالم وصل إلى ما هو عليه عبر تحولات صناعية وتقنية وقفزات اقتصادية وتغيرات فكرية، ينظر كل جيل إلى الوقت بشكل مختلف عن الجيل السابق. كلنا يعرف قصة السباق بين الأرنب والسلحفاة، فالأرنب بالنسبة إلى السلحفاة سريع ويقفز، ولكن في السباق تنتصر السلحفاة البطيئة، وهذا يعني أن السرعة ليست دائمًا محببة أو مرغوبة، وإنما يمكن للإبطاء والتركيز على الهدف أن يكونا هما مقياس الجودة والنجاح. فهل أن السرعة دائمًا أفضل؟ أم أن الإبطاء يمكن أن يجلب نتائج أفضل؟ هل يجب علينا الاستعجال في كل الأمور من أكل وقيادة سيارة وعبادة ووظائف العمل؟ أم أننا يمكن أن نقوم بكل هذا في حركة أكثر بطئًا؟
في سنة 1982م صاغ طبيب أمريكي يدعى “لاري دوسي” مصطلح “مرض الوقت”، لوصف الاعتقاد الوسواسي أن “الوقت ينفذ، ولا يوجد ما يكفي منه، وأن عليك الإسراع باستمرار للحاق به”. وغالبنا ينتمي لعقيدة السرعة التي يقول بها هذا الطبيب. يسلط الكاتب الكندي كارل أونوريه - وهو صحفي يعيش في المملكة المتحدة - الضوء على حركة الإبطاء من خلال كتابه المعنون بـ”في مديح البطء: حراك عالمي يتحدى عبادة السرعة”. تناول في كتابه الذي نُشر عام 2004م حالة السرعة، وكيف تعاملت معها بعض الدول والمنظمات غير الربحية من خلال وضع برامج ودساتير، وتطبيقات على مناحي عدة من الحياة مثل الأكل، الدراسة، الطب، المواصلات، العمل وغيرها. هذه البرامج كانت مزيجًا من جهود فردية ومجتمعية ومؤسسات أهلية وبعضها حكومية. سأسلط الضوء في هذا المقال على أهم أفكار الكتاب، ولكنه لا يغني عن قراءة الكتاب الغني بالتفاصيل المهمة والمقابلات والإحصائيات التي توثق حاجة العالم اليوم لحركة الإبطاء.
يشيد الكاتب بحركة “الطعام البطيء” التي ظهرت في إيطاليا عام 1986م عن طريق “كارلو بتريني” الكاتب المتخصص في الطهو، وذلك بعد أن بدأت مطاعم الوجبات السريعة بغزو شوارع المدن الإيطالية الكبرى. إيطاليا، كما غيرها، بلد له عاداته وتقاليده في الأكل، فهو يتمتع بزراعة وافرة ومحاصيل متنوعة. لم يرتضِ رواد الطعام في إيطاليا أن تتغير عادات أسلافهم، وتُستبدل الأطباق التقليدية المعدة بتمهل وبمهارة عالية بالأكلات المحضرة بسرعة تُلتهم في غضون دقائق لمواكبة سرعة الحياة. رأى كارلو بتريني أن الحركة هي انطلاقة جيدة لمعالجة الهوس بالسرعة في جميع مناحي الحياة، ونص بيان الجماعة على أن “صلابتنا في الدفاع عن المتع المادية الهادئة، هي السبيل الوحيد لمعارضة الحماقة العامة المتمثلة في حياة السرعة. ينبغي أن نباشر دفاعنا بدءًا من طاولة الطعام، ومع حركة الطعام البطيء”. اجتذبت الحركة برسالتها أكثر من 78 ألف عضو في أكثر من خمسين بلدًا، واتخذت من مدينة “برا” الإيطالية مقرًا لها، تُنظم فيها ورش عمل، وزيارات مدرسية، وأسواق خيرية تختص بالمنتجين المحليين والعالميين. حتى أنها افتتحت جامعة لتعليم علوم الطهي والمأكل وخصائص الطعام. لم تعنَ الحركة بطهي الطعام بشكل بطيء فقط، وإنما بطريقة إنتاجه، حيث ساعدت المنتجين المحليين في أنحاء العالم على اتباع خطوات لمواجهة الإنتاج السريع الذي فرضته الشركات الكبرى التي تتلاعب بالمحتوى الغذائي بشكل جائر وغير طبيعي. أنقذت الحركة الكثير من الأطعمة البلدية المهددة بالانقراض في إيطاليا وخارجها وساعدتها بالحصول على موطئ قدم في السوق العالمية.
يصف الكاتب المدينة بأنها مسرّع جسيمات عملاق، فكل ما في حياة المدينة من أصوات نشاز، وسيارات، وحشود، ونزعة استهلاكية، يدعو الناس إلى الاستعجال بدلًا من الاسترخاء، والتأمل والتواصل مع بعضهم البعض في هدوء. بالعودة إلى بلدة “برا” الإيطالية، فقد أصبحت بفضل حركة الطعام البطيء، وبمرسوم قانوني، مكانًا مثاليًا للهروب من صخب الحياة، فيجلس أهلها في أيام العمل العادية طويلاً لتناول القهوة على طاولات الرصيف، يقضون الوقت في الأحاديث، ويراقبون العالم هاربين من جنون السرعة الذي يجتاح العالم المعاصر. ظهرت بعد ذلك فكرة “المدن البطيئة” التي تراعي عذوبة الحياة من ضبط أوقات فتح المحلات، وتخفيف الضوضاء، وكمية الإضاءة في الشوارع، وتقييد سرعة السيارات إلى أقل حد، وزيادة مناطق المشاة، وإضافة المسطحات المائية والخضراء. ستكون فكرة المدن البطيئة جذابة لمن يقطن في مدن فوضوية لاهثة مثل لندن ونيويورك وطوكيو. ولا يعني السكن في مدينة بطيئة أن الناس فيها كسالى، أو لا يرغبون في العمل، بل إنهم ينتهجون أساليب في مختلف مناحي الحياة ليضبطوا سرعة إيقاعهم، بحيث يكونوا هم المتحكمين في الوقت، لا أن الوقت دائمًا يحكمهم، ويستهلك أبدانهم، ورغباتهم في الاستمتاع بلحظات الحياة. تقول نائبة بلدية “برا”، برونا سيبيلي: “ليس من السهل أن نسبح ضد التيار، لكننا نعتقد أن أفضل طريقة لإدارة المدينة هي اعتماد فلسفة البطء”. في سنة 2003م أُطلقت تسمية “مدينة بطيئة” رسميًا على ثمان وعشرين بلدة إيطالية، وتدفقت الطلبات لهذا النهج في عدة مدن أوروبية ومناطق بعيدة مثل النرويج وأستراليا واليابان.
في سنة 1982م صاغ طبيب أمريكي يدعى “لاري دوسي” مصطلح “مرض الوقت”، لوصف الاعتقاد الوسواسي أن “الوقت ينفذ، ولا يوجد ما يكفي منه، وأن عليك الإسراع باستمرار للحاق به”. وغالبنا ينتمي لعقيدة السرعة التي يقول بها هذا الطبيب. يسلط الكاتب الكندي كارل أونوريه - وهو صحفي يعيش في المملكة المتحدة - الضوء على حركة الإبطاء من خلال كتابه المعنون بـ”في مديح البطء: حراك عالمي يتحدى عبادة السرعة”. تناول في كتابه الذي نُشر عام 2004م حالة السرعة، وكيف تعاملت معها بعض الدول والمنظمات غير الربحية من خلال وضع برامج ودساتير، وتطبيقات على مناحي عدة من الحياة مثل الأكل، الدراسة، الطب، المواصلات، العمل وغيرها. هذه البرامج كانت مزيجًا من جهود فردية ومجتمعية ومؤسسات أهلية وبعضها حكومية. سأسلط الضوء في هذا المقال على أهم أفكار الكتاب، ولكنه لا يغني عن قراءة الكتاب الغني بالتفاصيل المهمة والمقابلات والإحصائيات التي توثق حاجة العالم اليوم لحركة الإبطاء.
يشيد الكاتب بحركة “الطعام البطيء” التي ظهرت في إيطاليا عام 1986م عن طريق “كارلو بتريني” الكاتب المتخصص في الطهو، وذلك بعد أن بدأت مطاعم الوجبات السريعة بغزو شوارع المدن الإيطالية الكبرى. إيطاليا، كما غيرها، بلد له عاداته وتقاليده في الأكل، فهو يتمتع بزراعة وافرة ومحاصيل متنوعة. لم يرتضِ رواد الطعام في إيطاليا أن تتغير عادات أسلافهم، وتُستبدل الأطباق التقليدية المعدة بتمهل وبمهارة عالية بالأكلات المحضرة بسرعة تُلتهم في غضون دقائق لمواكبة سرعة الحياة. رأى كارلو بتريني أن الحركة هي انطلاقة جيدة لمعالجة الهوس بالسرعة في جميع مناحي الحياة، ونص بيان الجماعة على أن “صلابتنا في الدفاع عن المتع المادية الهادئة، هي السبيل الوحيد لمعارضة الحماقة العامة المتمثلة في حياة السرعة. ينبغي أن نباشر دفاعنا بدءًا من طاولة الطعام، ومع حركة الطعام البطيء”. اجتذبت الحركة برسالتها أكثر من 78 ألف عضو في أكثر من خمسين بلدًا، واتخذت من مدينة “برا” الإيطالية مقرًا لها، تُنظم فيها ورش عمل، وزيارات مدرسية، وأسواق خيرية تختص بالمنتجين المحليين والعالميين. حتى أنها افتتحت جامعة لتعليم علوم الطهي والمأكل وخصائص الطعام. لم تعنَ الحركة بطهي الطعام بشكل بطيء فقط، وإنما بطريقة إنتاجه، حيث ساعدت المنتجين المحليين في أنحاء العالم على اتباع خطوات لمواجهة الإنتاج السريع الذي فرضته الشركات الكبرى التي تتلاعب بالمحتوى الغذائي بشكل جائر وغير طبيعي. أنقذت الحركة الكثير من الأطعمة البلدية المهددة بالانقراض في إيطاليا وخارجها وساعدتها بالحصول على موطئ قدم في السوق العالمية.
يصف الكاتب المدينة بأنها مسرّع جسيمات عملاق، فكل ما في حياة المدينة من أصوات نشاز، وسيارات، وحشود، ونزعة استهلاكية، يدعو الناس إلى الاستعجال بدلًا من الاسترخاء، والتأمل والتواصل مع بعضهم البعض في هدوء. بالعودة إلى بلدة “برا” الإيطالية، فقد أصبحت بفضل حركة الطعام البطيء، وبمرسوم قانوني، مكانًا مثاليًا للهروب من صخب الحياة، فيجلس أهلها في أيام العمل العادية طويلاً لتناول القهوة على طاولات الرصيف، يقضون الوقت في الأحاديث، ويراقبون العالم هاربين من جنون السرعة الذي يجتاح العالم المعاصر. ظهرت بعد ذلك فكرة “المدن البطيئة” التي تراعي عذوبة الحياة من ضبط أوقات فتح المحلات، وتخفيف الضوضاء، وكمية الإضاءة في الشوارع، وتقييد سرعة السيارات إلى أقل حد، وزيادة مناطق المشاة، وإضافة المسطحات المائية والخضراء. ستكون فكرة المدن البطيئة جذابة لمن يقطن في مدن فوضوية لاهثة مثل لندن ونيويورك وطوكيو. ولا يعني السكن في مدينة بطيئة أن الناس فيها كسالى، أو لا يرغبون في العمل، بل إنهم ينتهجون أساليب في مختلف مناحي الحياة ليضبطوا سرعة إيقاعهم، بحيث يكونوا هم المتحكمين في الوقت، لا أن الوقت دائمًا يحكمهم، ويستهلك أبدانهم، ورغباتهم في الاستمتاع بلحظات الحياة. تقول نائبة بلدية “برا”، برونا سيبيلي: “ليس من السهل أن نسبح ضد التيار، لكننا نعتقد أن أفضل طريقة لإدارة المدينة هي اعتماد فلسفة البطء”. في سنة 2003م أُطلقت تسمية “مدينة بطيئة” رسميًا على ثمان وعشرين بلدة إيطالية، وتدفقت الطلبات لهذا النهج في عدة مدن أوروبية ومناطق بعيدة مثل النرويج وأستراليا واليابان.
تُعتبر السيارة الخصم الأول للمدن البطيئة، فالسيارات الحديثة صُممت لكي تسرع، وهذا ما نشاهده عند عرض الإعلانات التجارية لها، وكيف أنها تتسارع لتصل إلى 100 كلم/الساعة في بضع ثوانٍ، وغيرها من القدرات المحفزة للسرعة. أصبحت الضغوط الرامية إلى إبطاء حركة المرور أقوى اليوم من أي وقت مضى، فقد زرعت الحكومات مطبات السرعة في كل مكان، وضيقت الشوارع، وملأت الطرقات بكاميرات الرادار، وخفضت الحدود القصوى للسرعة، وفرضت العقوبات على المخالفين. في إحدى المقاطعات الإنجليزية، بدأت الشرطة المحلية في تقديم خيار لأي شخص يُقبض عليه متجاوزًا الحد حتى 5 ميل/الساعة، فإما أن يحضر المخالف دورة إرشادية ليوم واحد، أو أن يدفع غرامة مع تسجيل نقاط سوداء على رخصة القيادة. إحدى التجارب التي ذكرها الكاتب، هي وضع مجموعة من المخالفين في أحد فصول مدرسة ابتدائية قد درّب الطلاب فيها على تقريع المخالفين، فتسأل إحداهم: “ماذا لو اصطدمت وقتلتني وأنت تسرع؟”، ويسأل آخر بشكل مشابه فيه لوم وتقريع، فيظهر على بعض المخالفين التأثر الشديد لدرجة بكاء بعضهم. المشكلة في معظم تدابير مكافحة تجاوز السرعات من رادارات ومخالفات هي أنها تعتمد مبدأ القسر والإكراه، فنحن لا نبطئ من أجل الإبطاء ولكننا مضطرون. فالطريقة الوحيدة لكسب الحرب على السرعة هي أن نعالج ما هو أعمق، أن نعيد صياغة علاقتنا بأكملها مع السرعة نفسها. نحن بحاجة إلى الرغبة في القيادة ببطء ليس من أجل القوانين، بل من أجل ثمرة البطء نفسه والراحة التي تجتاح أنفسنا.
وإذا كان رتم الطعام وقيادة السيارة يتسم بالسرعة، فما هي سرعة أذهاننا وتفكيرنا بالنسبة إلى سرعة خارج ذواتنا؟! عندما نخوض الحرب على السرعة، تكون خطوط القتال الأمامية داخل رؤوسنا. أي ما لم يتم ضبط سرعة الذهن، ونمط التفكير في داخلنا، فإننا سنكون عرضة لمحفزات السرعة في الخارج، فعلينا أن نتعمق أكثر، ونغير الطريقة التي نفكر بها. بمقدور الدماغ أن يُصنع الكثير إذا كان في حالة نشاط قصوى، لكنه سيفعل أكثر من ذلك بكثير إذا ما أُتيحت له فرصة الإبطاء من وقت إلى آخر. يمكن لتخفيض نشاط الذهن أن يحقق صحة أفضل، وأن يمنح هدوءًا داخليًا، وتركيزًا معززًا، وتفكيرًا أكثر إبداعًا، وقرارات مصيرية صحيحة، ويمكن أن يجلب لنا ما يسميه ميلان كونديرا “حكمة الإبطاء”. غالبًا ما تكون حالة الاسترخاء والتأمل مقدمة تستهل التفكير البطيء، حيث أظهرت الأبحاث أن التفكير الخلّاق يزداد عندما يكون المرء هادئًا، ومتأنيًا وغير مُجهد. كما أظهرت أن ضغط الوقت ومراقبته يؤدي إلى رؤية نفقية. يمكن ممارسة التأمل ودمج تمارين التنفس معه، وذلك بأخذ استراحات قصيرة أثناء العمل تمتد لعشر دقائق في كل مرة، فهي مفيدة لإعادة السكينة إلى الذهن، وزيادة الوعي، ولتجنب الغرق في أجواء العمل. تعد اليوغا أفضل الأساليب المتبعة عالميًا لممارسة الاسترخاء والتأمل، وليس ذلك فحسب، فهي تضيف - حسب ممارسيها - مرونة للجسم، وقوة تركيز عالية، وتعزز من الصبر، وتخفف من الشعور بنفاذ الوقت، وتنقل الهدوء والبطء إلى فعاليات الحياة الأخرى مثل العمل والأكل والمشي والقراءة. وهناك ممارسة أو رياضة تشبه اليوغا تُسمى “التشي كونج”، وهي عبارة عن تمارين بطيئة تعزز الصحة من خلال توزيع الطاقة على الجسم، فهي تدمج بين اليوغا والتأمل والحركة.
تمتد حالة الإبطاء حتى في التمارين الرياضية والصالات المخصصة لرياضة كمال الأجسام التي تمتلئ بأجهزة ومعدات ثقيلة، ويملؤها الأصوات الصاخبة، والرغبة في الحركة بسرعة وبقوة عنيفة. تنتشر في دول عديدة فكرة “السوبر سلو” وهي تمارين رفع أثقال تُمارس بطريقة بطيئة وبأوزان قليلة، حيث يمكن أن يستغرق التكرار الواحد لخمس ثوانٍ بدلاً من المعتاد. يدعي الكاتب من خلال بحثه، ومقابلات أجراها وتجربته للسوبر سلو، أن هذه التمارين قد تعطي مفعولًا إيجابيًا مماثلًا وربما أفضل من تمارين الأيروبيك، أو من جداول التمارين المتعارف عليها في الصالات الرياضية. لا تحتاج تمارين السوبر سلو إلى الوقت الطويل في اليوم الواحد، فهي مكثفة بحيث لا تستمر أكثر من عشرين دقيقة، ولا إلى الذهاب المتكرر إلى الصالة الرياضية، فيكتفي الممارس المبتدئ بالراحة من ثلاثة إلى خمسة أيام بين الجلسات.
هل صادفك يومًا وأثناء زيارتك للطبيب أنه يطرح عليك الكثير من الأسئلة ولا يتسنى لك الوقت لشرح حالتك؟ فالطبيب غالبًا ما يستغرق وقتًا أطول في إدخال المعلومات إلى الحاسب، وصنع فاتورة العلاج، ووضع قائمة الأدوية، وطلب أشعة وتحاليل، أكثر من الوقت الذي يستمع فيه إلى حالة المريض. والنتيجة بعد الانتظار الطويل قد تكون سرعة في التشخيص والعلاج، ونتائج غير مرضية، مع معاناة من أعراض جانبية لأدوية متعددة. يعرف الكثير منا هذا الشعور، فالأطباء في مستشفيات العالم يتعرضون لضغوط كي يتعاملوا مع المرضى بسرعة. فبدلاً من أخذ الوقت الكافي للاستماع إلى المرضى، واستقصاء جميع جوانب صحتهم وحالتهم الذهنية ونمط حياتهم، يميل الطبيب الكلاسيكي إلى التركيز على أعراض المرض وإهمال أسبابه الرئيسية. لهذا يلجأ بعض الناس إلى العلاج التكميلي والبديل مثل الوخز بالإبر، أو الأعشاب، أو التدليك الذي يدعي أنصاره بأنه يساعد في العلاج عندما يفشل الطب الغربي. تقول عالمة النفس إنغريد كولنز: “عندما نمنح المرضى الوقت والاهتمام، فإننا نمكنهم من الاسترخاء، وهو بداية الشفاء”. وهذا يؤكد على صلة العقل بالجسم، فحين نقبل أن المريض شخص يمر بحالات ومشاعر وقصص يود أن يرويها، يصبح من غير المقبول اختزال معاناته بوصفة طبية سريعة. لكن السرعة في الطب، وكما هو الحال في الكثير من مناحي الحياة الأخرى، مطلوبة في بعض الأحيان، فمثلاً في الحالات الطارئة أو أثناء العمليات الجراحية، تكون السرعة عاملاً حاسمًا حيث يجب أن يقرر الطبيب على الفور الإجراء الصحيح.
يرى المفكر الفرنسي بول لافارج (1842 – 1911م) في كتابه “الحق في الكسل”، أن العمل إلى حد الجنون هو مجرد غطاء أيديولوجي هدفه استخدام الطبقة العاملة لصالح الطبقة المسيطرة، بإنهاكهم وحرمانهم من متع الحياة. تبنى بعض الساسة منذ أكثر من قرن آراء تقول إن التكنولوجيا ستوفر الوقت للعاملين ليعملوا ساعات أقل، لكن هذه التنبؤات تحولت لسذاجة، ففي القرن الحادي والعشرين لا يزال كثيرون يعملون لأكثر من 45 ساعة أسبوعيًا، يأملون بقضاء وقت للعائلة والسفر والهوايات. أحد الأسباب هو المال، لكن نهمنا الاستهلاكي جعلنا نستبدل الوقت بالدخل. دراسة في اليابان أظهرت أن من يعملون 60 ساعة أسبوعيًا معرضون لنوبة قلبية ضعف من يعملون 40 ساعة. وفي كندا، أقر 15% من الموظفين بأن العمل قادهم لحافة الانتحار. عندما يأكل العمل حياتنا، تصبح الإنتاجية أقل حتى في العمل نفسه. يقول “كيبو أويوا” في كتابه “البطء جميل”: “الجيل الجديد في اليابان صار يقول كفى! لسنا مطالبين بالعمل ساعات طويلة، ومن غير المعيب أن نكون بطيئين”. يبدو أن الجدال سيطول بشأن تقليل ساعات العمل، لكن المتفق عليه أن هذا هو مطلب إنساني قبل أن يكون اقتصاديًا.
لا يولد الأطفال مهووسين بالسرعة، بل نحن من يدفعهم لذلك. المنافسة تُحرك أولياء الأمور لدفع أطفالهم نحو الإنجاز السريع، والمدرسة أصبحت ميدانًا لتحقيق المراتب لا للتعلم. يدفع الأطفال ثمن هذا النهج، فلا يتاح لهم وقت للتمهل أو اللعب. تشير الأدلة إلى أن الأطفال يتعلمون أفضل حين يكون التعليم أبطأ وأقل صرامة. دعا أستاذ التربية “موريس هولت” إلى “التعليم المدرسي البطيء”، وهو تعليم يُشبه الغذاء الصحي مقابل شطائر الوجبات السريعة. ومنح الوقت الكافي لاستكشاف المواضيع، لا لحشو المعلومات. تتبنى فنلندا هذا النموذج، ونتيجته أنها تتصدر التصنيفات التعليمية في العالم، حيث يبدأ التعليم الرسمي عند سن السابعة، وتغيب الاختبارات حتى المراهقة، مما يتيح فرصة حقيقية للنمو السليم.
في الختام، يقدم الكاتب حلولًا لإعادة ضبط الإيقاع داخل الإنسان. كالحياكة، والبستنة، والقراءة التأملية، والأنشطة الفنية، كلها تعزز البطء الإيجابي. اليوم، ومع اجتياح الذكاء الاصطناعي والتقنية، نتساءل: هل نحن بحاجة لحركة إبطاء أكثر من أي وقت مضى؟ الجواب نعم. السر يكمن في التوازن، لا في النقيض. أن نفعل الأمور بالسرعة المناسبة. أن نهدأ، أن نضبط أعصابنا، أن نكون أسياد الوقت لا عبيده. فلسفة البطء تمنحنا الصحة، والعلاقات، والبيئة، والتحرر من سباق لا نهاية له.