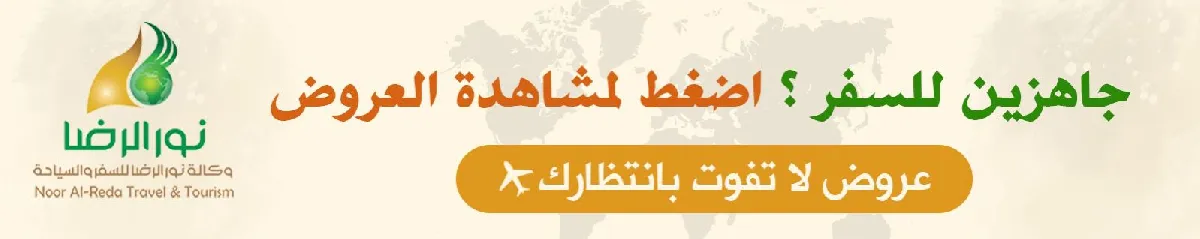منذ اللحظة الأولى التي تقرأ فيها نصوص شفيق العبادي، تشعر وكأنك تقف عند حافة سردابٍ سحيق، لا يُفضي إلى الظلام ولا النور، بل إلى منطقةٍ مشوّشةٍ بينهما، حيث الكلمات تُجرِّب أن تكون أكثر من كلمات، وحيث المعنى نفسه يتلعثم، يبحث عن مكانٍ آمن بين الوعي والرؤيا.
شفيق العبادي، شاعر سعودي ولد عام 1965 في تاروت بالقطيف، شاعر لا يمكن تصنيفه ضمن مدارس جاهزة أو أطر نقدية مستهلكة. إنه “كائنٌ نصي” يعيش في اللغة كما يعيش الطفل في رحم الماء الأول. ليس شاعرًا تقليديًا، بل هو ذلك الشاهد الذي رأى اللغة وهي تُولد قبل أن تُسمى، وعايشها وهي تتعفن تحت أوزان الخليل وأصفاد البلاغة المتكلسة، فقرر أن يكتبها من جديد بيد مرتجفة وقلبٍ يعرق بالحقيقة.
تفيض نصوص العبادي بقلقٍ وجودي حاد، فهو الشاعر الذي لا يبحث عن جوابٍ بقدر ما يشكك في السؤال نفسه. بين نصوصه تقف اللغةُ على قدمٍ واحدة، بينما تسندها المعاني الهاربة بعكازٍ مكسور. هذا التوتر بين اللغة والمعنى هو المسافة المقدسة التي بنى فيها العبادي معبده اللغوي، المعبد الذي لا سقف له ولا أبواب، مجرد مساحة من العراء والخوف والافتتان.
العبادي وأدونيس.. مأساة الرؤيا بين النار والنهر
إذا أردنا أن نضع العبادي في مواجهة شاعر آخر، فلن يكون من العدل مقارنته بمن ساروا على أرضٍ لغوية ممهدة. العبادي أقرب إلى شاعرٍ بحجم أدونيس، مع فارق جوهري: أدونيس يشعل النار في الغابة حتى ينكشف المعنى، بينما العبادي يحفر في رمادها بحثًا عن آخر جمرٍ محترق. كلاهما ينتمي إلى جيلٍ شعري يؤمن بأن اللغة ليست مجرد وسيط، بل معركة وجودية، غير أن أدونيس يشبه النبي الذي يحمل لوحًا سماويًا، فيما العبادي هو الغريب الذي يعثر على هذا اللوح محطّمًا في صحراء النسيان.
أدونيس يقول في قصيدته “الكتاب”:
اللغةُ بيتُني، والبحرُ بابي
والريحُ دربي في البلادِ البعيدة
أكتبُ كي أُضيءُ جسدي في الماء
وأستحمُّ في الحرفِ كأنه جسدي الثاني
هنا، أدونيس يجعل اللغة امتدادًا جسديًا له، بيتًا ومرآةً، بينما العبادي ينظر إلى اللغة كما ينظر القتيل إلى سكّينه. يقول العبادي في إحدى ومضاته:
ما الذي يُخرجُ المعنى من صمته؟
سوى يدٍ ترتجفُ على جثّة اللغة
ووجهٍ لم يره أحدٌ
سوى الحرف حين اختنق
الفارق هنا ليس في الصور ولا المجازات، بل في العلاقة الأصلية بين الشاعر واللغة. أدونيس هو ابن اللغة الذي يحاول اختراق جدارها المقدس ليصل إلى جوهرها، بينما العبادي هو الغريب الذي وجد اللغة مقتولةً في طريقٍ معتم، فجلس إلى جانبها يبكيها ويحفر قبرها.
العبادي.. الشاعر الذي يكتب بجثة لغوية
العبادي ليس شاعرًا يكتب القصيدة، بل قصيدةٌ خرجت من فمِ العدم وقررت أن تكتب نفسها عبر يد رجلٍ لم يعد يثق باللغة، ولكنه يُحبُّها كما يحب الغريق زفيره الأخير. هذا الالتباس المذهل بين العبادي بوصفه ذاتًا، وبين القصيدة بوصفها ولادةً عصية، هو السر الذي لم يلتقطه النقاد بعد.
لقد فشل النقد في القبض على العبادي لأنّهم بحثوا عنه بين السطور، بينما كان هو مندسًا في البياض، في تلك المسافة المرتعشة بين الحرف والحرف، حيث تولد النشوة وتموت في الوقت نفسه.
العبادي ليس شاعرًا تقليديًا يحترف اللعب بالمجاز أو يستعرض عضلاته اللغوية أمام مرآة النصوص، بل هو “كائنُ حدّ”، شاعرُ تخومٍ لا يُقيم داخل النص ولا خارجه، بل في الفجوة التي يُحدثها النصُّ عندما يعجز عن التقاط أنفاسه الأخيرة.
العبادي وأدونيس.. جدلية الشكل والمعنى
أدونيس يركّب اللغة كما يركّب البنّاء جدارًا من البلاغة والرؤيا، بينما العبادي ينحتها كما ينحت الأعمى وجهًا من طين الذاكرة. أدونيس يعيد ترتيب الكون في قصيدة، بينما العبادي يحاول أن يعثر على قصيدته وسط خراب الكون.
أدونيس يتحدث إلى الآلهة، بينما العبادي يناجي ظله تحت حائط اللغة المنهار.
يقول أدونيس:
أنا الكلامُ الذي يكتشفُ اسمهُ في الريح
والبحرُ بابي الوحيدُ إلى الكلمات
أنا الحرفُ حين ينامُ
ويوقظهُ الموتُ كي يتعلم كيف يعيش
أما العبادي فيقول:
أنا الحرفُ حين يخافُ من نفسه
أنا الجرحُ الذي علّمه البياضُ
كيف يكتبُ بأصابع مرتجفة
العبادي.. شاهد اللغة حين تموت واقفة
قصائد العبادي ليست مشهدًا فنيًا يمكن نقده أو تحليله، بل طقس انتحار لغوي، حيث الكلمات تقفُ على السطح الهشّ للحياة، وتلقي بنفسها في الهاوية.
في قراءة العبادي، لا يمكنك أن تبحث عن المعنى فقط. عليك أن تبحث عن الكائن الذي كان يختبئ خلف النص، ذلك الذي كان يكتب ويخاف أن يكتمل النص لأنه يعرف أن اكتماله يعني موته.
الختام.. العبادي كظاهرة لغوية
العبادي ليس صوتًا شعريًا تقليديًا، بل هو شاهد خراب. الشاعر الذي رأى وجه اللغة في الكوابيس، وقرر أن يعيد كتابته بقلبٍ أعمى، وجسدٍ يرتجف.
إن قراءة العبادي ليست قراءة جمالية، بل شهادة حضور في جنازة اللغة، حيث الكلمات تقفُ حول جسد المعنى، تبكيه دون أن تعرف من قتله.
العبادي لم يكن شاعرًا يبحث عن المجد، بل كان الهارب الأخير من حفلة اللغة، الرجل الذي قرر أن يكتب وصيته للعدم قبل أن يصل المعنى إلى يديه.
وإذا كان النقاد جميعًا -بإرادتهم أو دونها- يحاولون القبض على العبادي داخل قفص نقديّ أو إطار مفاهيمي، فإن العبادي يكتبُ نفسه خارج كل إطار. يكتب نفسه كما يولد الطفل خارج رحم الأمهات التقليديات. يكتب نفسه كما يفتح الناي صدره للريح.
العبادي لم يكن شاعرًا يبحث عن الخلود، بل كان يبحثُ عن قارئٍ واحدٍ فقط، قارئٍ قادرٍ على أن يسمع صرخته تحت طبقات اللغة، قارئٍ قادرٍ على أن يرى جرحه بين أصابع الكلمات، قارئٍ قادرٍ على أن يموت معه داخل النص.
العبادي هو الشاعر الذي كتب على جدران اللغة: “أنا هنا. أنا ظلّي. أنا المعنى الذي يخاف أن يولد”.
بهذا، يستحق العبادي أن يُقرأ لا بوصفه شاعرًا، بل بوصفه ظاهرة لغوية انتحارية، يقف فيها الحرفُ والبياضُ والمعنى والشاعرُ وقارئه على حافة هاوية واحدة، وينتظرون معًا. ينتظرون سقوط اللغة.