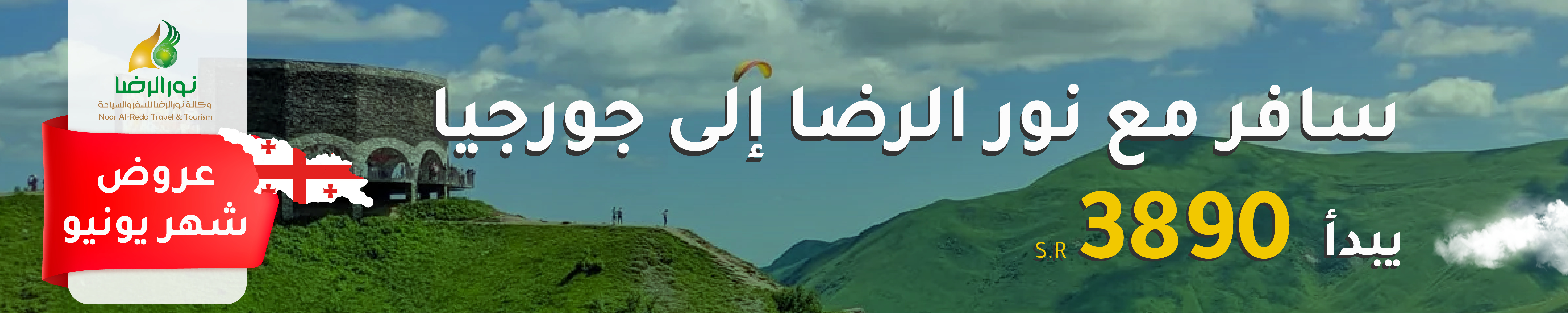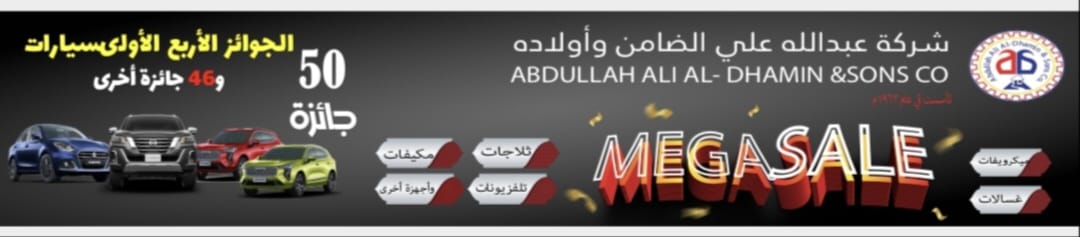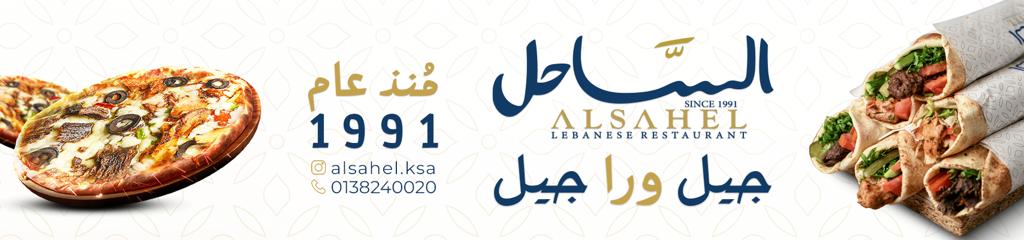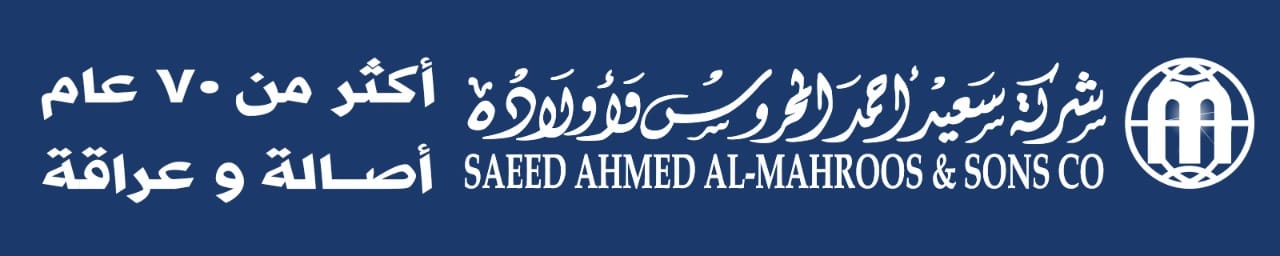تقدم السباعية البروسية ملحمة زمنية تعود بالقارئ إلى الماضي وكأنه يستعيد أحداث الأمس وينظر لها من اتجاهات متغايرة، تختلف عن نظرته الأولى التي اعتقدها صحيحة، وظنها الوحيدة الحقيقية، فالأكاذيب تنكشف، ولا تنطلي عليه حينئذ.
صدرت الترجمة العربية الثانية (الأولى عبر دار شرقيات) عن دار الجمل، وتكونت من سبعة أجزاء، تقع في حدود خمسة آلاف صفحة، لتشكل بذلك إحدى أطول الروايات في العالم، وتتميز إضافة لطولها بجملها الطويلة والمتتابعة التي ترهق القارئ، ما لم يكن مستعداً لذلك.
تطرح الرواية قضايا عدة وعلى نحو التركيز الشديد؛ حيث تعيد تدويرها ضمن أكثر من جزء، كقضية “دريفوس” التي نالت شهرة واهتماماً من الطبقة المثقفة إبان القرن التاسع عشر.
ومن القضايا كذلك التي يطرحها الراوي وتعالجها الرواية هو حضور “ألف ليلة وليلة”، وتأثيرها على الكُتاب خلال العصور السابقة، (1)، وهذا الحضور اتخذ شكلين أساسيين: الأول: التأثير في الراوي، والثاني: التأسيس لأحداث القصص الداخلية في الرواية.
• التأثير في الراوي
يطرح أندريه موروا تساؤلاً حول سبب طول رواية “بحثاً عن الزمن المفقود”، والإجابة التي يقدمها تعود به إلى “ألف ليلة وليلة”(2)، حيث يؤكد أنها هي التي ألهمت الكاتب.
هذه النظرة الخارجية ليست وليدة رأس أندريه، فمارسيل بروست صرح داخلها؛ في معرض حديثه عن الشرق: “لم يراود خيالي شرق “ديكان” ولا شرق “ديلاكروا”، وإنما الشرق القديم كما في ألف ليلة وليلة التي أحببتها كثيراً، وبينما كنت أهيم في شبكة هذه الشوارع السوداء، فكرت في الخليفة هارون الرشيد يبحث عن مغامرات في الشوارع المنسية من بغداد” (3)، وهي إشارة دالة على تأثير كتاب الليالي في تشكيل الذهنية الغربية عن الشرق، الذي يحتفل بالغرائب والعجائب (4).
أيضاً نجد في نفس الجزء حديثه حول طول روايته ويصرح بـ “سيكون كتاباً بطول ألف ليلة وليلة ربما، ولكنه مختلف تماماً. لا شك أننا عندما نحب عملاً ما فإننا نرغب في فعل شيء مشابه له، ولكن يجب أن نضحي بهذا الحب الآني، وألا نفكر في أذواقنا، وإنما في حقيقة لا تطلب منا ما نفضله، وتمنعنا حتى من التفكير فيه. وفقط عندما نتبعها نصادف أحياناً ما تخلينا عنه، ونجد أننا كتبنا “الحكايات العربية” عندما نسيناها” (5)، وهو تصريح يحمل من الدلالات الكثير، فتأثير “الليالي” يتجاوز المحيط العربي إلى العالم، وما العودة إليها بالإشارة تارة أو التصريح أخرى إلا دلالة على هذا التأثير وقوته (6).
أثناء حديثه عن البندقية، يُدهش لجمال أبنيتها ومتاحفها وكنائسها، فيتوقف عن السرد ويُفسح المجال أمام مشاعره: “كنت أخرج وحيداً في المساء، وسط المدينة السحرية فأجد نفسي، في الأحياء الجديدة، كشخصية من شخصيات “ألف ليلة وليلة” (7).
ولا يتوقف هنا، بل يكمل توصيفه للبندقية واكتشافه لساحة واسعة وقصور فخمة، فإذا به يُشبهها بـ”قصور الحكايات الشرقية التي نجلب إليها في الليل شخصية روائية، ثم نعيدها إلى منزلها قبل طلوع الفجر، بحيث لا تجد المسكن السحري وينتهي بها الأمر إلى الاعتقاد بأنها لم تذهب إليه إلا في الحلم” (8).
التأثير يبلغ مداه في الجزء السابع، حيث لا يزال يتحدث عن رحلته، إذ يشير إلى “فندق السفراء القديم في مدينة البندقية الذي يحتوي على صالة للتدخين جُلبت كما هي من قصر شهير نسيتُ اسمه، على غرار قصور ألف ليلة وليلة” (9).
لا تتوقف تأثيرات الليالي على المباني والساحات والفنادق، بل تصل إلى الحياة اليومية، والأطباق الشهية، ففي نفس الجزء (السابع) وبعد تناوله للطعام إذا به يتذكر “شخصية من شخصيات ألف ليلة وليلة راحت بعفوية تؤدي حركة لتُحضر بها جنياً مطيعاً ومستعداً لنقلها إلى مكان بعيد” (10)، والإشارة هنا إلى حكاية علاء الدين والساحر الأفريقي.
كما أنه في الجزء الأول أيضاً يصرح بهذا التشابه: “ونحن لا نزال جالسين أمام صحون الألف ليلة وليلة وقد أثقل علينا الحر وبخاصة الطعام” (11).
أما في الجزء الثاني فيورد التداخل بين محبوبته السابقة جيلبيرت والحلوى وارتباطها الذهني بالليالي العربية: “كانت تذكّرني بقصعات أقراص الحلوى الصغيرة، قصعات ألف ليلة وليلة التي كانت تسلي عمتي “ليوني” عظيم التسلية بموضوعاتها حينما كانت “فرانسواز” تجيئها يوماً بـ علاء الدين أو المصباح السحري وآخر بـ علي بابا أو النائم اليقظان أو السندباد البحري الذي يبحر من البصرة حاملاً كل أمواله” (12).
• التأثير في الرواية
لا ينفصل نوعاً التأثير إلا بمقدار محدود، فامتداد الأثر ينتقل من الذات إلى المكتوب الحكائي، وهو ما شاهدنا بعضه، وتالياً سنكمل بقية التأثير المرتبط ببناء الحكاية التي يقدمها بروست، حيث يعتبر بأن الأساس الذي اعتمد عليه هو الحكايات العربية، وأنه كتبها من حيث نسيها، فرواية “بحثاً عن الزمن المفقود” وهي تطرح قضاياها وتقوم بتشريحها تستحضر “ألف ليلة وليلة”، وتوليها أهمية كبرى لتقريب الصورة إلى ذهن القارئ، مثل حديثه عن النوتة الموسيقية أو الرسوم التوضيحية والمنمنمات أو حديثه عن الألوان وتوزيعها.
حين يتحدث عن النوتة الموسيقية التي تمثل محوراً هاماً من محاور بناء المعمار الفني للرواية (13) يشير إلى أنها “تشبه الزخرفات العربية” (14)، وهو دليل على أن للثقافة العربية انتشاراً وحضوراً راسخاً في ذهنية القارئ الغربي وفي تشكيل وعيه الجمالي، فالموسيقى تأخذ أفكاره بعيداً “وددت لو كنت واحداً من أشخاص ألف ليلة وليلة التي كنت أقرؤها دون انقطاع والتي فيها فجأة في فترات الحيرة والشك جني أو فتاة يافعة فاتنة الجمال تخفي على الآخرين لا على البطل المرتبك الذي تكشف له بالضبط ما يرغب في معرفته” (15).
أما حين يتحدث عن تقاسيم الجسد الذكوري وجمال الوجوه، فيعود إلى الزخارف الموجودة في الإنجيل وفي منمنمات ألف ليلة وليلة، وينسبها: “لرسامين كان عليهم وضع رسوم إيضاحية للأناجيل أو لكتاب ألف ليلة وليلة ففكروا بالبلاد التي يجري فيها المشهد وجعلوا للقديس بطرس أو لعلي بابا بالضبط الوجه الذي لأضخم شخصية في “بالبيك” (16).
على مستوى الألوان وتوزيعها وجمال تناسقها وعلاقتها بالموسيقى، يصف بروست (الموشور الضوئي) في أحد مشاهده “كأنما ذلك كنز غير متوقع ومتعدد الألوان، عن سائر الأحجار الكريمة في “ألف ليلة وليلة”. ولكن كيف نشبه بهذا التألق اللا متحرك للنور ما كان حياة وحركة دائمة وسعيدة؟” (17)، فعبر المشابهة بين الحدثين يستدعي الذاكرة التي ترى أن الشرق العربي غني بحكايات أسطورية وعوالم سحرية لا تنتهي، وهي مصدر الجمال ومعيار التناسق.
أما على المستوى النفسي والتعبير عن الحالات التي تعتري الإنسان، فيلجأ بروست إلى استعارة عبارتين من عبارات ألف ليلة وليلة، هما: “وقد انشرح فؤاده، وهو في غاية الارتياح” (18)، وهذا يدل على عمق التأثير الثقافي لكتاب الليالي على الفرد والذهنية الأوروبية ومساهمته في تشكيلها وتحديد سماتها.
كذلك يظهر تأثير حكايات ألف ليلة وليلة على شخصيات الرواية، حيث تقول جوبيان للراوي: “ظننت أنني، كالخليفة في ألف ليلة وليلة، وصلت في الوقت المناسب لأجد رجلاً كان يُضرب، وإذا بي أمام حكاية أخرى من حكايات ألف ليلة وليلة، حكاية المرأة التي مُسخت كلبة تُضرب بطوعها كي تستعيد شكلها الأول” (19).
• خلاصة
أكثر من خمسة عشر مقطعاً توزعت بين تأثيرات على الراوي وتأثيرات على الرواية.
هذه التأثيرات لها امتداداتها الثقافية داخل الذهنية الغربية، وذلك ما اتضح عبر المقاربة مع الموسيقى والعمارة الهندسية وتناسق الأجسام والأثر النفسي بما هو أثر ثقافي مُترحل من ثقافة لثقافة ودال على الارتياح وانشراح الصدر، وهنا يمكن القول: إن كتاب “بحثاً عن الزمن المفقود” يدين بالفضل في ظهوره إلى كتاب “ألف ليلة وليلة”، الذي قرأه بروست، ثم نسيه، فعاد ليكتب حكاياته بلغته الخاصة الممتزجة بثقافته.
هوامش
1- مومسن كاثرينا، جوته وألف ليلة وليلة، ترجمة: أحمد حمو، مطبوعات وزارة التعليم العالي، سوريا – دمشق 1980م، ط1، ص89: لقد ألهبت الليالي خيال القراء الفرنسيين وتركتهم يحلمون بأجوائها السحرية الدافئة، ولعل من مظاهر ذلك الأثر ما اعترف به الأوربيون أنفسهم من عظيم مكانتها عندهم، فلقد وصف (أويسترب) أهميتها بقوله: “فيما عدا الكتاب المقدس لا توجد سوى كتب قليلة حققت انتشاراً واسعاً وطافت العالم بأرجائه مثل مجموعة “ألف ليلة وليلة” لأنه يكاد يوجد في معظم البلدان المتحضرة من يقرأ هذا الكتاب بسرور مرة واحدة على الأقل في حياته”.
2- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: إلياس بديوي، منشورات الجمل، بيروت – بغداد 2019م، ط1، ج1، ص134.
3- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: جمال شحيد، ج7، ص141.
4- محسن جاسم الموسوي، ألف ليلة وليلة في الغرب، دار الجاحظ للنشر، العراق – بغداد 1981م، د. ط، ص36: كل شيء خارق وعجيب، والهدف فيها هو إثارة عجب القارئ ودهشته.
5- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: جمال شحيد، ج7، ص404.
6- شريفي عبد الواحد، ألف ليلة وليلة وأثرها في الرواية الفرنسية في القرن الثامن عشر، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر – وهران 2005م، د. ط، ص89: اكتسيت حكايات الليالي أهمية كبرى بانتشارها في العالم، فقد أثارت في نفوس قرائها رغبة في معرفة الشعوب التي أنتجتها وحثتهم على السفر إلى بغداد ومصر والشام وإيران والهند.
7- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: جمال شحيد، ج6، ص250-251.
8- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: جمال شحيد، ج6، ص251.
9- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: جمال شحيد، ج7، ص28.
10- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: جمال شحيد، ج7، ص203.
11- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: إلياس بديوي، ج1، ص226.
12- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: إلياس بديوي، ج2، ص533.
13- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: جمال شحيد، ج1، ص134: (يتساءل موروا): ما عسى أن تكون موضوعات سيمفونية “بروست” العظيمة؟
14- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: إلياس بديوي، ج1، ص379.
15- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: إلياس بديوي، ج5، ص277.
16- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: إلياس بديوي، ج2، ص352.
17- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: إلياس بديوي، ج5، ص283.
18- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: إلياس بديوي، ج3، ص453.
19- مارسيل بروست، بحثاً عن الزمن المفقود، ترجمة: جمال شحيد، ج7، ص165-166.