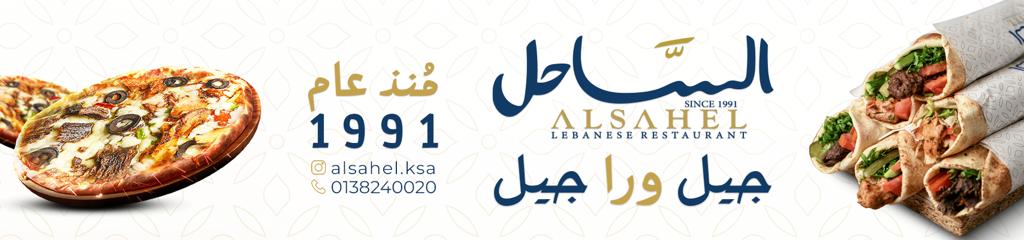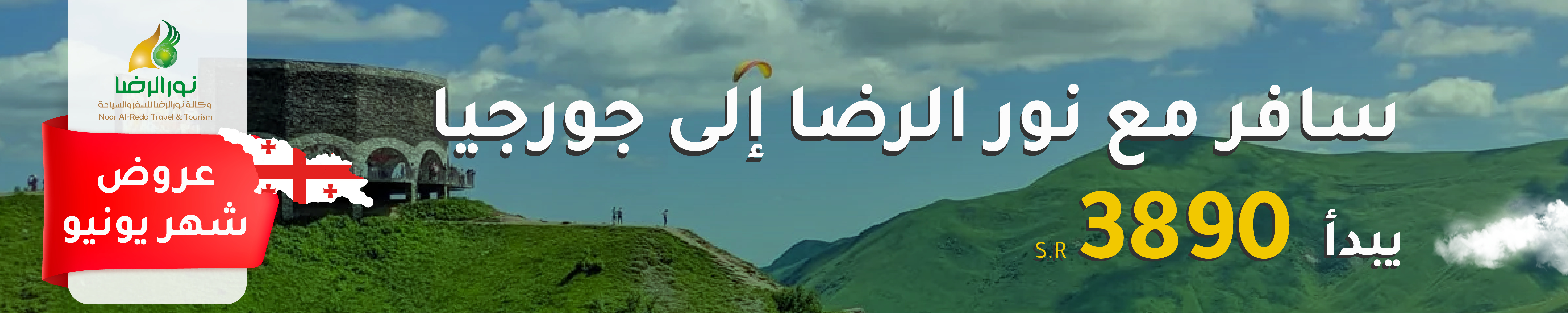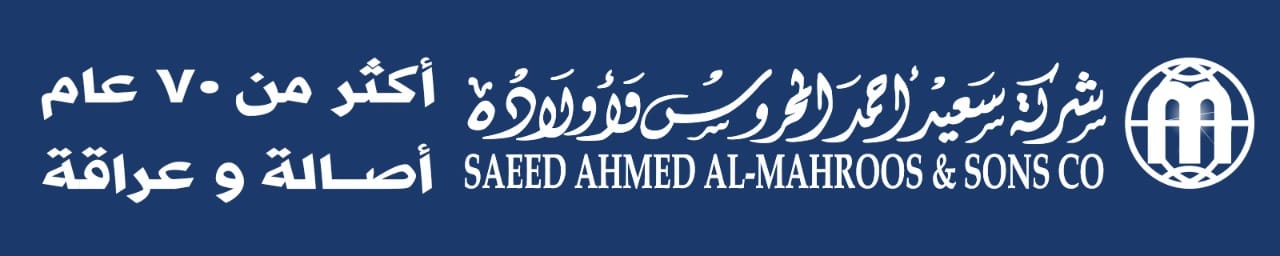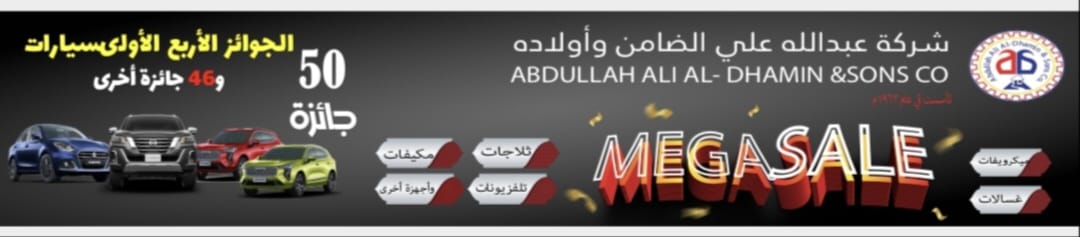“إن الناقد انشغالاته تكمن في اللغة الثانية التي يستنطق من خلالها النص؛ ليبحر فيه متأملًا، حاملًا بين أخيلته وما يختزله من أدوات وثقافة، قاربًا، يجدف بين أمواجه ناحية النص، ليصل إلى خضرة الشاطئ”.
بهذه الكلمات تحدث الأديب والروائي حبيب محمود عن الناقد وعن دوره في تحليل النصوص الأدبية.
وأشار محمود إلى أن التقسيمات، التي جاءت في الأدب؛ كالأدب الإسلامي، والعباسي، والقومي، والوطني، إلخ..، كان معولها البنية الموضوعية، موضحًا أن النص يرتكز على بنية الكلمات والصوت من خلال الوزن والقافية والصياغة والسياق، والكلمة والجملة، ودلالتها المكتملة والبنية الثقافية، وبنية الموضوع، حيث إنها تنقسم إلى الأفكار والعاطفة، مؤكدًا أن البنية الثقافية، هي الأصعب فيما يمارسه الناقد.
وقال: “إن النص يمتلك في جعبته لغة ثانية في مقابل اللغة الواقعية الأولى، ما نبصر سوادها على القرطاس، ولكن معانيها، وفي دلالتها قد تصطدم بواقعية اللغة الأولى”.
وأكد أن الناقد لا يقدم حكمًا أو تفسيرًا للنص، بقدر ما ينقب في زواياه وخفاياه، ويسكتشفه، ليستنطقه، مسقطًا ظل ثقافته، وخبراته على النص.
وأوجز ماهية الناقد في عمله، والتي ترتكز على الإجابة عن السؤال؛ ماذا يريد أن يقول هذا النص، مبينًا أن البحث عن الإجابة، وفك اللعبة الظاهرية والضمنية للنص، هي العملية النقدية للناقد، ملفتًا إلى أن الإبداع لا حدود له، والمبدع، يستشرفه أنى وجده، وأنى أراده أن يكون، وإن جاء في قلب الواقعية، وتصادم المعاني، فإنه قد يروم شيئًا، لم يأت متوافقًا في المعنى الظاهري للنص.
جاء ذلك خلال أولى جلسات ملتقى سدرة الثقافي، التي حملت عنوان “الإبداع والنقد”، وقدمها الشاعر والنحات السيد هاشم العلوي، مستضيفًا فيها، كلًا من: الكاتب والناقد المسرحي عباس الحايك، والأديب والصحافي حبيب محمود، والناقد محمد الحميدي، والناقد والقاص السيد يوسف الشرفا، وحضرها نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، وذلك مساء الجمعة بحي الناصرة.
الإبداع بوصلته ومكانته
وبيّن الناقد محمد الحميدي، في ورقته، التي جاءت بعنوان “لنتخيل”، بصفته سؤالاً والإبداع بصفته جوابًا، أن الناقد والمبدع يتناوبان على صورة، فيرسم المبدع الصورة في فضائه الخاص، مستمدًا مادتها من حياته، أو مخيّلته، أو الأحداث التي مرت على ذهنه، أو التقطها بحاسة من حواسه، أو ربما عبر خياله الخصب، والناقد إذ ذاك يمارس عمله في مراقبة الصورة وقراءتها واكتشاف مميزاتها وعيوبها وتنبيه المبدع إلى ما غفل عنه أو تجاوزه أو سقط منه سهواً دون علمه.
وذكر أن الإبداع، هو محاولة الإتيان بالجديد، وعدم الركون إلى المتوارث المألوف، وهذا ما نجح فيه بعض المبدعين، وأخفق فيه آخرون، موضحًا أن البعض نجح في مختلف الفنون، ملفتًا إلى أن شعوب الشرق والغرب لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بدعم مبدعيها، والأخذ بأيديهم، ولم تكن الأمم الماضية، لتُخلّد آثارها إلا على يد هؤلاء، كونها سنة كونية، يسير عليها الإنسان، مؤكدًا أن الأدب والفن، وكل ما يتصل بالإبداع والموهبة، هو السبب في خلود الأمم، في بقائها إلى اليوم، حية ومشاهدة أمامنا.
وأضاف أن الناقد لا يمتلك أمام الصورة، التي يرسمها المبدع إلا أن يقوم بعمله، الذي يتمثل في تحليل أجزاء الصورة، ومكوناتها إلى عناصرها الأولية، واستخراج الأفكار منها، والتأكيد على عناصر التفوّق، والإشادة بداخلها أو على العكس الإشارة إلى عوامل الضعف في بنائها وتركيبها، مؤكدًا أن عمل الناقد مكمل، ومتمم لعمل المبدع، ومشارك له في عملية الخلق الفني.
وتابع قائلًا: “الصورة تطرح أمامنا على شكلين؛ الأول بصفته إجابة عن استفسارات العالم، والثاني بصفته سؤالاً على تلك الإجابة التي جاءت، ومن هنا تأتي أهمية النقد للإبداع، فالإجابة اليوم تتحول إلى سؤال غدًا، والسؤال يتحول إلى إجابة بعد غد وهكذا”.
وأكمل: “أما من هو الذي يطرح السؤال، ومن هو الذي يجيب، فكلاهما قد ولدا في لحظة واحدة، ووجدا معًا، وكلاهما واصلا السير فيما بعد، وإن اختص المبدع بالخلق الفني أو ببناء الصورة، واختص الناقد بتحليلها والعمل على بيان تفرّدها وتميزها”.
وأشار إلى أن ثنائية الإجابة والسؤال كان لهما دور فاعل في التطور والتقدم الحضاري والثقافي، مثل حادثة تفاحة نيوتن المشهورة والتي لولاها لما افتتحنا عصر الفيزياء، ولظللنا على حالنا ألف سنة أخرى، فسقوط التفاحة لم يكن سوى بداية سؤال، وإجابته كانت “قانون الجاذبية”، أما إجابة قانون الجاذبية، فكانت سؤال ارتياد الفضاء والوصول إلى القمر.
وأوضح أن ذلك مثله مثل الرومانسية، التي جاءت سؤالاً في البداية عن الكلاسيكية، ومن ثم تحول السؤال إلى إجابة فيما بعد، حينما أعقبت الرومانسية الكلاسيكية، واتخذت من الفرد ومشاعره الأساس في التعبير.
وأردف قائلًا: “هنا يطرح السؤال على الرومانسية المغرقة في الخيالات: أين هو واقع الناس الحقيقي في الفن والأدب؟ والإجابة كانت تأسيس المذهب الواقعي، وانتشاره على حساب الرومانسي في الكثير من الأرجاء”.
ودعا قائلًا: “لنتخيل قليلًا؛ ماذا كان سيحل بالعالم لولا وجود ثنائية السؤال والإجابة.
أدبية النقد المسرحي إقصاء العرض
وطرح الحايك، في ورقته النقدية عن المسرح، التي حملت عنوان “النقد المسرحي بين الأدبي والفني”، تعريفًا للنقد، لجميل حمداوي، بأنه عميلة وصفية تبدأ بعد عملية الإبداع مباشرة، وتستهدف قراءة الأثر الأدبي ومقاربته قصد تبيان مواطن الجودة والرداءة، ملفتًا إلى أن الخطاب النقدي، هو كتابة موازية للخطاب المسرحي، أو خطاب حول خطاب؛ كما يعبر رولان بارت.
وتناول مفهوم النقد المسرحي، واختلاف القراءات النقدية للنص المسرحي، بين من انحاز للنص المسرحي منطلقًا من النقد الأدبي الكلاسيكي، وبين من انحاز للعرض المسرحي بعناصره البصرية غافلاً عن النص، منوهًا إلى أن النقد المتكامل، الموازن الذي يقرأ العرض المسرحي من عناصره الثلاثة، أولاً اللساني، ويعني النص المسرحي بكافة أنواعه، إن كان نصًا أصيلاً أو معدًا للقراءة أو معدًا عن رواية أو قصيدة أو ديوان شعري، مؤكدًا أن الناقد لا بد أن يدرك نوع النص، الذي هو بصدد نقده.
وتابع بقوله: “ثانيًا السيميائي، كل ما تبصره عين المتفرج على الخشبة، وتشمل الديكور، وإضاءة وحركة الممثلين، والعناصر المشهدية، وقال: وعليه لا بد على الناقد أن يلم بهذا العنصر، ويقرأ العرض من خلاله، ثالثًا الصوتي، ويعني الإلقاء وفصاحة الممثلين والأداءات الجماعية والموسيقى، والمؤثرات الموسيقية والصوتية”، مؤكدًا أن هذه العناصر الثلاثة، لو ألم بها الناقد، بالضرورة سيكتمل نصه النقدي، ويقدم خطابًا نقديًا متوازنًا، دون الانحياز لأي عنصر على حساب العناصر الأخرى.
تفاضلية النقد واستشرافيته
وتطرق الشاعر والنحات السيد العلوي في ورقته، التي حملت عنوان “حول القد والإبداع” إلى أهمية التفريق بين ما يسميه “النقد الأفقي التفاضلي” و”النقد العمودي الاستشرافي”، موضحًا أن النقد الأفقي التفاضلي، يتناول الناقد فيه حالة فردية أو منتجًا فرديًا منفصلاً، كقصيدة شعرية، أو لوحة فنية، أو قصة، أو رواية، أو مسرحية أو تصرف سلوكي فردي، ليأتي العمل النقدي منصبًا على عمل واحد، وليس على مجمل النتاج المعرفي لهذا المبدع.
وقال: “كثيرًا ما يُفصل العمل أو النص عن السياق الزماني والمكاني للحالة الإبداعية المسيطرة، وفي الغالب، يجيء غير ممنهج، وتكثر فيه النظريات والآراء غير الناضجة، وتسيطر عليه الذاتية والمزاجية والذوق، والنتيجة والتي عادة ما تكون انطباعًا ذاتيًا استهلاكيًا غير موضوعي بصفة عامة، بعيدًا عن قراءة التجربة الكلية للمبدع أو مقارنتها بالسائد، وقياس مدى تقدمها أو تأخرها عن المستوى الأدبي أو الفني المزامن لها”.
وبيّن أن هذه الحالة كثيرًا ما نراها طاغية في يومنا هذا، كنوع من الترف النقدي، في المهرجانات والمسابقات والدوريات الثقافية والصحف المكتوبة أو الإلكترونية، تثير في كثير من الأحيان الجدل الآني والاتهامات المتبادلة بين الناقد والمبدع أو محبي هذا المبدع، في كونها تجريحًا إن كانت لا ترضي صاحب العمل، أو تلميعًا لصورة مبدع في نظر من لا يوافقون الناقد في طرحه.
وتابع قائلًا: “النقد العمودي الاستشرافي، نقد بعيد عن الذاتية، موغل في الموضوعية، يرتكز على منهجية مختصة وواضحة، تقبل التأويل والنقاش، ويكون هدفَه نقد الحالة المعرفية أو الثقافية العامة المسيطرة زمانيًا ومكانيًا على مجتمع ما، وأن يكون هذا النقد فتحًا جديدًا واستشرافًا لآفاق معرفية أرقى جديدة ومؤسسة، يطمح الناقد للوصول إليها حتى وإن اصطدم هذا الطرح بمدى التوقع أو الفهم العام”.
ولفت إلى أن مدى التفهم محكوم بمدى أهلية المتلقي أو المجتمع لفكرة التطوير العمودي والتقدمية المعرفية، وتلك حالة كثير ما يفتقر إليها المجتمع العربي بسبب عدم الفهم أو “استعجال الفهم” أو الرفض أحيانًا لدور وأهمية النقد الاستشرافي البنّاء.
ونوه إلى أن كثيرًا من النقاد العموديين حين يهمون بنقد الحالة الإبداعية العامة، منطلقين من عمل فردي واحد أو جماعي، يختارون حالة إبداعية متفق عليها مبدئيًا على أنها رائدة ناضجة أو أنها الأبرز، ولا يضيعون جهدهم على المستويات غير الناضجة، والتي هي محط اهتمام النقاد التفاضليين التعليميين، وبالتالي يبعدهم عن وصمة الانتقائية أو الشخصانية البحتة.
وقال: “أما في آرائهم النقدية الاستشرافية، فإننا نجد الغالبية منهم لا يجزمون بما توصّلوا إليه من حكم، وإنما نجدهم يتركون الأبواب مواربة، ويكثرون من وضع علامات الاستفهام على حساب وضع النقطة، وأول السطر.
الصناعة النقدية احتراف
وأكد الناقد والقاص السيد يوسف الشرفا، في ورقته النقدية، التي حملت عنوان “العملية النقدية كصناعة”، أن النقد صناعة، معرفًا إياه بكونه مجموعة من الأفعال أو الخطوات، تأتي ضمن نظام محدد، وتنفذ على معطيات محددة للوصول إلى نتيجة أو منتج يمكن الانتفاع منهما.
وأشار إلى المهام المترتبة على من يدير العملية النقدية بمعناها الحرفي الصناعي، وهي: فهم طبيعة المعطيات وحجمها، والقدرة على انتخاب النظام المتوافق، ومعرفة حدوده، وتحديد مستواه، وضمان التطبيق الأمثل لآلية النظام، وترتيب شبكة الأفعال، والخطوات، بحيث تتفاعل المعطيات بطريقة مقننة للحصول على منتج، والخروج بمنتج يمكن الاستفادة منه بطريقة ما.
وبيّن أن العملية النقدية لا يمكن إنجازها لحظيًا، مؤكدًا أن العمليات النقدية، تتطلب معرفة وإدارة ومتابعة؛ ووقتًا وجهدًا، ومهارة وتركيزً، ملفتًا إلى أن المنتجات النقدية قد تكون رأيًا أو رؤية؛ تبعًا لطبيعة المعطيات، ومستوى الإدارة، وقال: مع التطور المفترض في الصناعة، بعض المعطيات تتطلب إدارة عملياتها النقدية خلق توليفة من الأنظمة للوصول بهذه المعطيات إلى نتيجة أو نتائج نقدية يمكن الانتفاع بها، موضحًا أن العملية النقدية التي يُرجى منها نتائج أو منتجات نقدية عالية الجوة تتطلب، أحيانًا، اشتراك أكثر من شخص في إدارتها، تبعًا لحجم وطبيعة المعطيات، وسعة النظام أو توليفة الأنظمة المنتخبة.