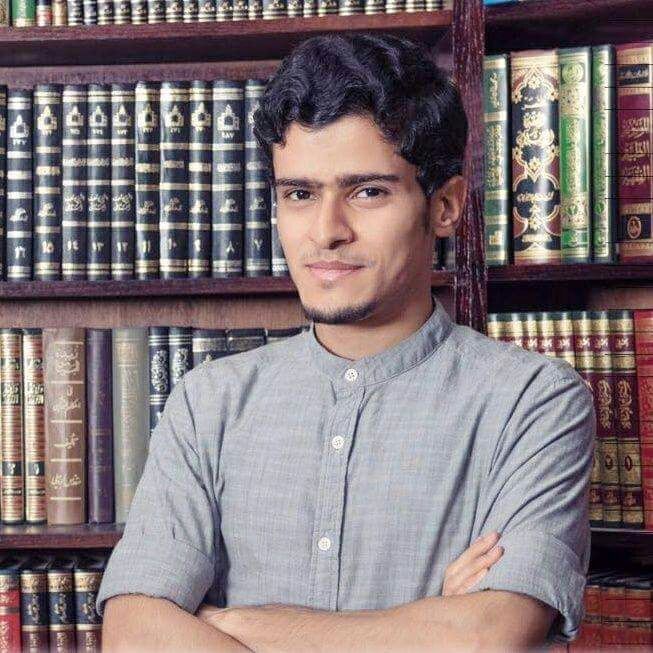
تنبض الحروف بصدق العاطفة والدمعة حينما تقترب من وجع وألم قد حدث وكان له أثر خالد على مدى قرون من الزمن وما يزال؛ يقترب الشاعر من ثقب “الونَّةْ” يهدي حروفه ومشاعره وكلماته إلى الذاكرة الممتدة والأثيرة في نفوس محبي وعاشقي الإمام الحسين (ع)، وتضحيته الكبرى في سبيل علو الحق وزرع بذور الحقيقة وتجذرها في أصالة المبدأ وشموخ القيمة في تاريخ الأمة الإسلامية.
تتجه هذه القيمة في مقامات الجنة، عند مقام الشهادة الحسينية وأثرها في الوعي العقدي والثقافي والفكري؛ في معنى الشهادة والحياة؛ وفي تجليات الدرب الذي يأتي لينشر النور رغم عواصف وشتات الفتن والظلمة؛ في هالة الاشتعال الداخلي عند ذكر أبيات شعرية تفيض منها كل مشاعر الحزن والمأساة وألم الفراق.
يقول علي مكي الشيخ: ” إِننا نهربُ إلى كربلاءَ.. | لا لأننا نجدُ الأمانَ فيها.. | بل لأنها تشبه اللَّهبَ الذي يشتعلُ داخلنا !!”.
هي أثر لا يُنسى، ومسيرة من التضحية تشتعل فيها قلوب النفوس التواقة إلى نور الحق الإلهي، حزن يُذّكرنا بحزن النبي يعقوب لفقد ابنه النبي يوسف (عليهما السلام)؛ حينما تبيّض العين من الفقد والحنين؛ هذا وهو فراق سيستعيده القميص اليوسفي ليكون بلسمًا شافيًا لأثر الحزن، حياة تعود للعين وحياة تعود للحنين؛ فكيف سيبدو الحزن لراحل قائد للكلمة الصادقة ووارث الأنبياء والمرسلين وهو يرحل عن الحياة الفانية نحو حياة الجنة؛ نحو السعادة الحقيقية التي يعشق في إعلاء كلمة الله.
فهذه هي النفوس التي تبكي تنبض بدموع الأسى لتستعيد فيها روح الانتماء للفطرة والقيمة الأصيلة لخلافة الإنسان للأرض، لتأدية الأمانة المعهودة التي في أعناق البشر، هذه الدموع تتناثر ويتناثر معها توليفة المعاني التي ترسم للأيام سطور الأمانة الأخلاقية والقيمية وترسيخ كل معنى يجعل الأرض تتنقى من الفساد فيها.
يقول الشيخ في ديوانه “نقش خاتمه”: ضمن عنوان “انتماء”:
“قُمْ وتوضأ | بتراب الوجعِ الحافي فوقَ | صهيلِ الكفْ.. | منقوشٌ بين أصابعنا | وشمٌ.. | قد لاحَ ببرقةِ فِطرتنا | يا موتُ اخلعْ عَنْ ثوبكَ | خيطًا زرَّرْتَ به.. | قصةَ أهلِ الكَهَفْ | ما كُنَّا لو لم نزرعْ.. | في حقلِ رجولتنا | عشبًا | قد كان يُسمى.. “الطف”.
ويتجه الشيخ لتضمين سيد الشهداء في تجليات “المضمَرُ في الدَّهشة” بروح السعادة مع لقاء الله بـ: “ما سِرُّ الدهشةِ في المضمرِ.. | يا لمسكونةُ فينا.. رؤياهْ | فضحوك.. بيسراك الطف.. | ويمناكَ يكلمها اللّٰه..”.
يصف الشاعر علي مكي الشيخ كربلاء الطف بـ: “ترابٌ يُصْنَعُ منه الأرواح…”.
ويصف كربلاء في “صناعة الوجع” بأنها: “هي وحدها مَنْ يصنعُ تابوت جدرانها، بضجيج صمتها، وابتكار أنَوِيَّتها المؤثثةِ بذاكرة الأنبياءْ.. “.
هُنا في الديوان تسير اللغة نحو مزج المجاز بالواقع لكن من دون محو الحقيقة؛ مزج السعادة بالآهات التي سيأتي بعدها أُنسٌ إلهي؛ فلسفة الحزن المنتشي بالجمال المغلف لتبديد تعب السنين والصبر على المآسي؛ جماليات لحظات ذرف الدموع لتتبلسم الأحداق من جفاء الأيام؛ برهنة الأثر الجميل في التذكير بواقعة الطف من ناحيتها الإدراكية وترسيخ الوعي بقيم الحياة.
ينظر الشيخ لكربلاء في “صناعة الوهج”: “كجمال أخضر في مضامينها فلسفة الأشجار التي في النهاية عند الحشر ستكون قطفة لفاكهة الأحرار”.
يتنفس كربلاء من لحظة غيب في فضاء اللامكان، يسرد شيئًا من الحدث الكربلائي يذّكر الشعراء ألا تصبح قصائدهم الحسينية باهتة ودون معنى عميق يحيي القضية والمبدأ فيها.
يكتب عن الموت، حينما يبدو لا يشبه كينونته كموت، ينقش فيه سيمياء الأثر الفريد والمدهش في كون الموت حق؛ وفي ذات الوقت يكون الموت في كيان الحسين بطولة شهيدة وشاهدة معجونة بتراب الحياة، تصنع من الموت حياة خالدة بنقش خاتم اليد الطاهرة التي شهدت على الظلم والظلمة.
وكوّنت في خاتمه الشريف خير معنى وتجذر عظيم للشهادة نحو الكرامة في بطولة خالدة تُنقش في أعماق التاريخ، وسيكتب التاريخ كل العبارات والأمكنة المشاعرية التي لا حدود للتعبير عنها في عمق الوجع والمأساة، ونحو أبيات شعرية وسطور نثرية تبوح بكل ما في عمق المشاعر لتنقش عشقها وحبها الأجمل والأقدس.























